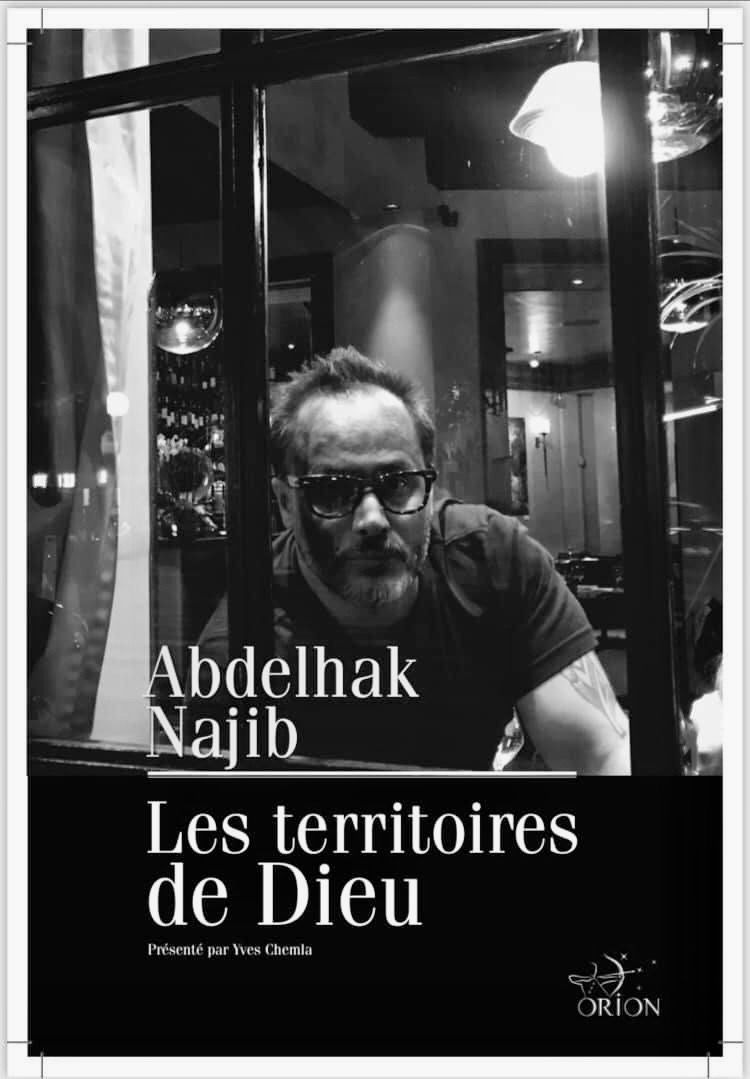
اقتصادكم
في الحي، ومن بين المائتي ألف روح ملعونة تعيش هنا، نستطيع ان نستثني واحدة أو اثنتين ممن يمكن حقا إصلاحهم. البقية باعوا أرواحهم للفساد وللشيطان بلا ميثاق. لأجل هذا، كانوا يتمتعون بجرعات زائدة من الشجاعة، لا، بل كانوا قد ضيعوا الجولة وسلموا مصيرهم للصدف. كنا لا نزال شبابا ونحن نتساءل كيف يستطيع هذا البلد الاستمرار مع كل أنواع الحثالة بسياسة هؤلاء المبتذلين اللقطاء، البدينون المتعفنون، غريب كيف يستطيع هذا البلد الاستمرار بفضل القدرة الإلهية.
صديقي علي كان يقول بأن على السياسيين أن يكونوا فاشلين في السرير مثل دواسات صغيرة مكبوحة. في اعتقادي، العاهرات الذين هم يطِؤون في غرفهن الصغيرة القذرة، لديهن رجولة أكثر مما لديهم، لأنك إذا لاحظت جيدا، مع بطونهم المتدلية لن يتمكنوا من المضاجعة بشكل طبيعي، يقول علي، وحتى وهم مستلقون على ظهورهم مع بقراتهم السمينات اللواتي يترنحن فوق أعضائهم، لن يتمكنوا من إشباع شهواتهن. ولكن هذا ليس كالتقبيل ونحن واقفون خلف الأبواب، داخل أقسام الثانوية، أو خلف الشاحنات المتوقفة في الحي. الضروري أن يكون صلبا بشدة وبطن مسطحة مثل صفيحة من حديد. نعم، كانت هذه إحدى أكبر نظريات صديقي علي حول السياسة.
على أي، بعيدا عن المال، ماذا كان لديهم أكثر؟ لا شيء، كان لدينا كل الباقي، كل ما ترفض أن تقدمه الحياة للمعتوهين. كان لدينا الظهر الصلب. كان لدينا القدرة على القتال من أجل الفتاة التي نريد ونمنع غيرنا من الاقتراب منها، كل حروب العصابات المجنونة تلك، حيث كل واحد منا يضع خطته العسكرية والتي يتم توظيفها بنجاعة لعدم وجود أي قواعد. كان لدينا مقابلات كرة القدم حصص رفيعة جدا، برهانات جادة تتوقف على الشرف، السمعة العائلية، كلمة السر المقدسة للحي، اسم فلان للدفاع، وهكذا.... كانت مقابلات الكرة هذه، حيث كل واحد منا ترك جزءا من جسده، نتفة من جلده، سنا أو ساقا مكسورة، أو إصبعا متوعكا، أو ثقبا بخمس سنتمترات في الراس. الضريبة الثقيلة التي يجب دفعها لكي يكون للحياة طعم. كل هذا المزيج من الأرواح المفككة يجرون حول كرة من المطاط، يجرون خلف قطعة من الحرية، خيط من الضوء يخبرنا أنه بالرغم من كل شيء، نحن كنا أسياد العالم. وهو ما نعتقده، المضحك في الامر، هو أننا في الفرقة، الحياة لها معنى بضربة جزاء أو ضربة حرة. كل شيء يتوقف على ضربة حظ. هكذا كانت الحياة.
أمي كانت دائما تحضر المباريات. كانت تتنقل من حي لآخر لمتابعة إنجازات ابنها المعجزة، يجب القول بأنها كانت فخورة وهي تراني اتجاوز مدافعا كبيرا أو أراوغ بتمريرة بين لاعبين. كان ذلك ثمرة النجاح بالنسبة لها. كانت تقول للمتفرجين، لأنها كانت المرأة الوحيدة التي تجرؤ على التواجد بين الذكور لكي تتابع مقابلة جميلة في كرة القدم، تقول: " انظروا إلى الولد الذي قام بشد عنق خصمه الضخم هناك، إنه ابني، لديه ضربة قدم سحرية، يستطيع يوما ما جعلنا نعيش بواسطة قدمه المباركة". نعم أمي كان بإمكاني أن أجيد كرة القدم. أن أشق طريقي في الاحتراف مع النوادي، كنت سأربح الكثير من المال. كنت سأحصل على سيارة كبيرة، ككل زملائي الذين وقعوا اتفاقيات في فرنسا وألمانيا وغيرها، كان بإمكاني أن أتزوج من أجنبية، أن أنجب أبناء، أن يكون لدي حساب بنكي كبير وما إلى ذلك، لكني لم أفعل يا أمي، لأني أخترت ألا اعمل في كرة القدم، أريد أن تكون كرة القدم متعة أذهب إليها كلما تملكني الحنين، أن ألعب على شاطئ البحر مع الأصحاب، وأن العب مباريات في الحي، أن أكسر سنا من أجل تسجيل هدف، أن أناضل من أجل عشرة أهداف وأن أذهب إلى الحمام لأستريح من تعب اللعب، أمي.
بالنسبة لي، هذا هو ما يناسبني، ليس المجد هو ما يجعلني أقفز لمجرد رؤية كرة تائهة في دروب حينا.
في البداية لم تكن أمي متحمسة كثيرا لكرة القدم، كانت تريد أن أنتبه لدروسي لأنجح، وهو ما فعلته بالطبع، بعدها، بعد أن اطمأنت للشهادات التي نجحت في الحصول عليها، أصبح بإمكانها أن تشم رائحة المال الذي يأتي من كرة القدم، كانت تقول " مال سهل"، "لماذا لا تريهم من تكون؟"، " هذا الغبي ابن الجارة، ليس لديه جسد جميلᴉ لكنه يلعب جيدا في أحد أندية المدينة؟ نعم، ولكن ابن حليمة كان حقا غبيا، انتهى أمي، كان ذلك من أكثر الثوابت لدينا، كرة القدم لم تكن فكرة جيدة. أمي، وخاصة انني لست مثل ابن الجارة ولا أريد أن أكون مثله أمي.
في الحي، كنت اللاعب المأجور بامتياز، والفرق كانت تتنازع من أجلي. وأنا كنت سعيدا بهذا النجاح، كان على مقاسي، لم أكن أريد أن ألمع أكثر، أو بشكل مختلف. كنت أستطيع الأكل بعد مقابلتين، كما أستطيع أن أحصل على ما يكفي من المال لأذهب إلى السينما وأتفرج على " دو وال " ل "الان باركمع "بوب جيلدوف " هذا الفيلم المروع الذي مس كياني بشكل عميق وأنا بالكاد في الحادي عشرة سنة من عمري. كنت أرغب في أن أحلم بنهاية العالم ثم أعود ليلا إلى بيتي متأخرا، أن آخذ كتابا، لما لا، رواية "الغريب" لألبير كامو، مثلا، لكي أقرأه تحت مصباح الإنارة العمومية بالشارع الكبير الذي يحمل اسم الحزام الكبير، الشريان الطويل مع صف من المصابيح السيئة الإضاءة، على بضع كلومترات من الإسمنت ولا شجرة واحدة. قطط وكلاب ضالة وجائعة، وأنا. كنا نحن عشاق الليل في الحي، كنت أقرأ في الشارع، لأنه كان ممنوعا إشعال المصباح في بيتنا بعد إطفاءه، كانت أمي صارمة في هذا الموضوع.
كنت أتخيل نفسي حرا مثل بطل روايتي، أحلم بزوجة أستطيع أن أضمها إلى صدري موليا ظهري للعالم ولكل الناس، أحمل الشهادات، لكن مفلس، ومع ذلك سعيد لأن رأسي مملوء كما كان يقول أستاذنا في الثانوية، ذلك الإنسان الطيب الذي كان اسمه سيمحمد والذي كان يعيش على هامش المجتمع بصدقه وعفويته وتمرده، وشعر كشعر المسيح أو هكذا أخالني أراه. هذا الأستاذ كان يحبني، كان يقول، بأنه من المؤسف أن أظل في هذا البلد المتعفن، لأصدأ بين القاذورات. كنت أعرف بأني عالق حتى النخاع في القذارة، لكني لم أكن أهتم.